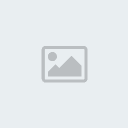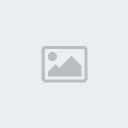سورة ص
((ص)) فيه أقوال منها أنه رمز بين الله والرسول، ومنها أن المراد أن القرآن الذي لا تتمكنون - أيها الكفار - من الإتيان بأقصر سورة منه، من جنس حروف الهجاء لـ"ص" وغيره، ومنها أنه اسمه لعين تنبع من تحت العرش، كما ورد عن الصادق (عليه السلام)، ومنها أنه اسم من أسماء الله تعالى، إشارة إلى اسم لكونه إشارة إلى "الصابر" أو "الصادق" إلى غيرها من الأقوال، وفي إعرابه أيضاً خلاف تبع الخلاف الأول، ((وَالْقُرْآنِ))، أي قسماً بهذا القرآن الذي هو ((ذِي الذِّكْرِ))، أي صاحب الشرف، كما يقال: "لفلان ذكر،" أي شرف بسببه يذكر في المجامع، أو المراد أنه صاحب التذكير بالله واليوم الآخر، ولا ينافي أن يكون هو ذكر - باعتبار بعض آياته - وأن يكون صاحب الذكر باعتبار مجموعة وجواب القسم محذوف، أي أنه لحق، دل عليه قوله: (بل الذين).
فليس في القرآن نقص يوجب عدم إيمانهم، فإنه حق ظاهر لا مرية فيه، ((بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا)) بالله واليوم الآخر ((فِي عِزَّةٍ))، أي تكبر عن قبول الحق، فإن الإنسان العزيز يعرض عن الرضوخ لغيره سواء كانت العزة واقعية أو عزة مزعومة، ((وَشِقَاقٍ))، أي مخالفة للرسول، والعدو مهما يرى الحق في جانب خصمه لا يرضخ له، ولا يقبل منه، مشتق من "شق"، وكأنه في شق وطرف، والخصم في شق آخر.
ولكن هل يبقون هؤلاء كذلك معرضين عن الحق أعداءً للرسول؟، كلا، فليعتبروا بالأمم المكذبة الذين سبقتهم، فـ((كَمْ أَهْلَكْنَا))، "كم" للخبر، يراد به التكثير، ((مِن قَبْلِهِم))، أي قبل هؤلاء الكفار ((مِّن قَرْنٍ))، أي من أمة، وتسمى الأمة قرناً باعتبار تقارن أعمار أفرادها، ((فَنَادَوْا)) عند إتيانهم العذاب بالاستغاثة والضراعة، لكن لم يفيدهم النداء في نجاتهم من العذاب، ((وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ))، أصل "لات" "لا"، زيدت عليه التاء، بمعنى "ليس"، و"مناص" من "النوص" وهو التأخر، يقال: "ناص يونص" إذا تأخر، وقد حذف خبر "لات"، أي ليس الوقت الذي استغاثوا فيه وقت التأخر للعذاب والنجاة لهم، فقد كانوا في مهلة ما دام أجلهم باق، أما إذا حقت عليه كلمة العذاب فلا تفيدهم الضراعة والاستغاثة.
((وَعَجِبُوا))، أي الكفار ((أَن جَاءهُم مُّنذِرٌ))، أي رسول من قبل الله سبحانه لإنذارهم وتخويفهم عن بأس الله، بأنهم إن تمادوا على الكفر والعصيان أخذهم العذاب وأُرْجِعوا إلى النار، ((مِّنْهُمْ))، أي من جنسهم، فقد كانوا يقولون: لولا يكون الرسول علينا ملائكة، ((وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا)) الرسول ((سَاحِرٌ كَذَّابٌ))، فإنه يسحرنا حين لا نتمكن من الإتيان بمثل القرآن وحين يأتي بخوارق، وهو يكذب على الله بأنه رسوله وأن الله إله واحد لا شريك له ولا صاحبة ولا ولد.
ثم جعلوا يستفهمون مستنكرين بقولهم ((أَجَعَلَ)) هذا الرسول ((الْآلِهَةَ)) المتعددة التي نقول بها ((إِلَهًا وَاحِدًا))؟ أي كيف يقول: أن لا إله إلا إله، واحد، والحال أن لنا آلهة متعددة؟ ((إِنَّ هَذَا)) الذي يقوله محمد من وحدة الإله ((لَشَيْءٌ عُجَابٌ))، أي لأمر عجيب مفرط في العجب.
قال بعض أن كل قبيلة كانت لها آلهة متعددة تبعاً لتنازع كان يقع بينهم، وقد كانوا يقولون أن هذه الكثرة من الآلهة لا تكفينا، فيجب صنع الآلهة جديدة، فلما قال لهم الرسل أن الإله واحد، قالوا: إنا لم نكتف بهذا العدد العديد من الآلهة فهو يدعونا إلى إله واحد؟
وهناك ظريفة تحكى هي أن الكفار اجتمعوا، وقالوا أن في القرآن كلمات غير فصيحة، وظنوها مأخذاً على الرسول، وجمعوا تلك الكلمات في ثلاث هي: "كبار" و"يستهزئ" و "عجاب"، وأتوا الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ناقدين للقرآن، فقال الرسول: "ائتوني بأفصحكم،" فذهبوا، وجاؤوا بشيخ كبير قالوا أنه أفصحهم، ولما حضر بين يدي الرسول أراد الجلوس، فقام الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فأخذ في القيام، فجلس الرسول، فأخذ الشيخ في الجلوس، فقام الرسول، فاستشاط الشيخ غضباً من هذا التمسخرية، وقال: "يا محمد أتستهزئ بي وأنا شيخ كبار؟ هذا أمر عجاب." وهناك نظر بعض القوم إلى بعض، وقد أبطل الشيخ دعواهم في جملة واحدة وانصرفوا خائبين.
ونقل أن المشركين اجتمعوا حول الرسول ليفاوضوه في ترك الدعوة، فقال لهم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): +"أتعطون كلمة واحدة تملكون بها العرب والعجم؟" فقال أبو جهل: "لله أبوك، نعطيك ذلك عشر أمثالها." فقال: "قولوا لا إله إلا الله،" فقاموا وقالوا: "أجعل الآلهة إلهاً واحداً؟" فنزلت هذه الآيات.
((وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ))، المراد بالانطلاق انطلاق الألسنة بالكلام، فقد قال الأشراف - وهو الملأ - بعضهم لبعض ولأتباعهم ((أَنِ امْشُوا))، أي سيروا في طريقكم التقليدي الذي يقول بتعدد الآلهة، ولا تعيروا كلام محمد بالآ<له>، ((وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ)) المتعددة، وتحملوه <وتحملوا؟؟> المشاق في سبيلها لئلا يغلبكم محمد، ((إِنَّ هَذَا)) البقاء على ديننا والصبر على المشاق في سبيل الآلهة ((لَشَيْءٌ يُرَادُ)) منا، فنحن مطلوبون عند العرف الاجتماعي بالحماية عن الشرك.
((مَا سَمِعْنَا بِهَذَا)) الذي يقوله الرسول من وحدة الإله وعدم الشرك ((فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ))، أي ملة أهل الكتاب التي هي خير الملل بعد الوثنية وما أشبههما، وكانوا أرادوا بذلك التمويه على العوام بأن أهل الكتاب أيضاً لا يقولون بوحدة الإله، فكيف يدعي محمد أنه مثل موسى وعيسى (عليهم السلام) يدعي ما لا يقولا به؟ ((إِنْ هَذَا)) الذي يقوله الرسول من التوحيد ((إِلَّا اخْتِلَاقٌ))، أي كذب، فقد خلقه وصنعه محمد، ولا نصيب له من الواقع، وقد رأى الكفار أهل الكتاب الذين انحرفوا عن منهاج التوحيد فجعلوهم حجة في مقابل الرسول، وإلا فالأنبياء جميعاً لم يقولوا إلا بالتوحيد، وهكذا أكد التوراة والإنجيل على ذلك.
ثم جعلوا يستغربون عن أن الرسول يكون موحى إليه من بينهم ظانين أنهم مثل الرسول في المؤهلات - إن لم يكونوا أفضل منه، فاللازم أن يوحى إليهم دونه أو إليهم وإليه على حد سواء، ((أَأُنزِلَ عَلَيْهِ))، أي على الرسول ((الذِّكْرُ))، أي القرآن ((مِن بَيْنِنَا))؟ كيف ذلك يكون وفينا من هو أكبر منه سناً ومالاً وجاهاً وأولاداً؟ لكنهم غفلوا، من أن مؤهلات الرسالة غير مؤهلات العرف والعادة، والرسول منفرد فيها، فليس قولهم هذا لنقص رواه في الرسالة والرسول،((بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي)) الذي أنزلته على الرسول، ولم يكن الشك بحق، فإنهم لو تفكروا علموا بصدق الرسول، وإنما شك المقلد الجاهل الذي يرى الحق في طرف والتقليد في طرف آخر، ((بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ))، إلى <أي؟؟> عذابي، حذف ياء المتكلم تخفيفاً، وهذا تهديد لهم، بمعنى أنهم إنما يقولون ما يقولون لا لعدم صحة الرسالة والدعوة، بل لأنهم منحرفون محتاجون إلى التأديب، وسيذوقون العذاب.
أما ما يقولون من أن اللازم نزول الذكر عليهم دون الرسول وقولهم (لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) فالجواب أن ذلك فضل الله يعطيه من يشاء، ((أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ)) حتى يفتحون خزائن الرسالة فيهبونها لمن شاؤوا هم دون من يريد الله سبحانه؟ ((الْعَزِيزِ)) في سلطانه، يفعل ما يشاء، ((الْوَهَّابِ)) العطايا لمن يشاء، ومن المعلوم أن الله سبحانه لا يهب إلا حسب المصلحة والحكمة، فإنما ينزل الرسالة لم يؤهلها، كما قال سبحانه (الله أعلم حيث يجعل رسالته)، وقال: (ولقد اخترناهم على علم على العالمين).
((أَمْ لَهُم مُّلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا)) حتى إذا شاؤوا أن لا يكون محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) رسولاً سدوا أبواب الوحي على وجهه، لأنهم يملكون طرق الوصول من السماء إلى الأرض؟ وإذا قالوا أنهم يملكون ذلك ((فَلْيَرْتَقُوا))، أي يصعدوا ((فِي الْأَسْبَابِ)) الموصلة لهم إلى السماوات ، ليمنعوا مسالك الرسالة، لئلا يوحى بالقرآن إلى الرسول.
إنهم ليسوا بمالكي خزائن الله، ولا لهم ملك السماوات والأرض، وإنما جماعة منبوذة تجمعت من لفيف جنود للباطل في ابتعادٍ عن التصرف في الشؤون الكونية، إنهم ((جُندٌ مَّا)) نكرة غير مربوطين بشأن من الشؤون، ((هُنَالِكَ)) منبوذة في زاوية من زوايا العالم، لا يرتبط بأمر من أمور الكون، ((مَهْزُومٌ))، هزمهم المنطق والحق، ((مِّنَ الْأَحْزَابِ)) ملتفة من أحزاب مختلفة ومذاهب مشتتة، فلم يجمعهم وحدة حقيقية وإنما الحسد والعناء والكبر، وإلا فما يجمع بين اليهودي والمسيحي والمشرك تحت قيادة أبي سفيان لمحاربة الرسالة الإلهية العظمى؟ و"جند" مبتدأ، و"هنالك" خبره و"مهزوم" صفة "جند".
إن مصير هؤلاء هو مصير من قبلهم من الكفار حيث كذبوا الأنبياء، فأهلكهم الله سبحانه بما كذبوا، وإن بقي هؤلاء في كفرهم وغيهم سيلاقون ذلك المصير المهلك، ((كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ))، أي قبل هؤلاء الكفار ((قَوْمُ نُوحٍ)) (عليه السلام) ((وَعَادٌ)) كذبت هوداً (عليه السلام) ((وَفِرْعَوْنُ)) كذب موسى وهارون (عليهما السلام)، ((ذُو الْأَوْتَادِ))، صفة فرعون، وقد سئل عن الصادق (عليه السلام): لأي شئ سمي فرعون ذا الأوتاد؟" فقال: "لأنه كان إذا عذب رجلاً بسطه على الأرض على وجهه، ومد يده ورجليه، فأوتدها في الأرض، وربما بسطه على خشب منبسط فوتد رجليه ويديه بأربعة أوتاد، ثم تركه على حاله حتى يموت."
((وَ)) كذبت ((ثَمُودُ)) صالحاً (عليه السلام) ((وَقَوْمُ لُوطٍ)) لوطاً (عليه السلام) ((وَأَصْحَابُ الأَيْكَةِ))، وهم قوم شعيب، وقد كانت إلى جنبهم غيضة ذات أشجار، وهي الأيكة، كذبوا شعيباً (عليه السلام)، ((أُوْلَئِكَ الْأَحْزَابُ)) الذين كذبوا الرسل، وكان قومك حزب من تلك، فما كان مصيرهم؟
((إِن كُلٌّ))، أي ما كل من أولئك الأقوام ((إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ)) الذين أرسلوا إليهم، ((فَحَقَّ))، أي ثبت ولزم عليهم ((عِقَابِ))، أي عقابي، وحذف الياء تخفيفاً، والمراد بالعقاب أخذهم بأنواع عذاب الاستيصال في الدنيا قبل الآخرة.
((وَ)) إذ عرف قومك مصير أولئك المكذبين، فما بقاؤهم في الكذب والكفر إلا انتظاراً لتلك العاقبة السيئة. ((مَا يَنظُرُ هَؤُلَاء))، أي كفار مكة ((إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً)) يصيح بهم جبرائيل أو ملك آخر حتى يهلكهم جميعاً كما حدث في بعض الأمم السابقة، أو المراد النفخة الأولى ((مَّا لَهَا))، أي ليس لتك الصيحة ((مِن فَوَاقٍ))، أي إفاقة بأن تنقطع قبل هلاك القوم، فيرجعوا عن غيهم وضلالهم، يقال أفاق من مرضه إذا طاب، وفواق الناقة هي المدة بين الحبستين لأن فيها يعود اللبن إلى الضرع.
وإذ كان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) يهدد الكفار بالعذاب، كانوا يقولون مستهزئين له (صلى الله عليه وآله وسلم): عجل لنا بالعذاب، ((وَقَالُوا))، أي الكفار ((رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا))، أي قدم لنا نصيبنا من العذاب ((قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ))، و"القط" هو النصيب، من"قط" بمعنى قطع، لأن النصيب يقطع ويعين في مقدار خاص.
قال الله سبحانه في جوابهم تسلية للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): ((اصْبِرْ)) يا رسول الله ((عَلَى مَا يَقُولُونَ))، أي ما يقوله هؤلاء الكفار في تكذيبك والاستهزاء بك، ((وَاذْكُرْ)) جماعة من الأنبياء الذين آذوهم قومهم فصبروا أو كانت لهم القوة الدنيوية بالإضافة إلى الإيمان الذي هو قوة معنوية تقوية لقلوب المؤمنين، ولئلا يقول المرجفون أن الإيمان لا يلائم الحياة الدنيا، فاذكر يا رسول الله ((عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ))، أي صاحب القوة، فإن "أيد" جمع يد، ثم استعملت في النعمة والقوة، لأن اليد من أسبابهما، ((إِنَّهُ)) (عليه السلام) - مع كونه ذا قوة عظيمة دنيوية - ((أَوَّابٌ))، أي تواب، يستغفر ربه في دائم الأحوال، من آب يؤوب إذا رجع، وكان <وكأن؟؟> الانشغال بأمور الدنيا كان انصرافاً عن الله سبحانه - ولو انصرافاً مباحاً - فكان يرجع إليه تعالى بصرفه نفسه كلها إليه كل صباح ومساء.
((إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ))، أي جعلناها مسخرة مع داود في كونها ((يُسَبِّحْنَ)) بتسبيح داود ((بِالْعَشِيِّ))، أي العصر، ((وَالْإِشْرَاقِ))، أي عند إشراق الشمس، فإذا داود كان إذا سبح الله تعالى في هذين الوقتين كانت الجبال تردد معه التسبيح، وقوله "يسبحن" بلفظ العاقل، لأن صدور محل العقلاء من الجبال يدخلها في جملتهم.
((وَ)) سخرنا لداود ((الطَّيْرَ))، المراد به الجنس، أي كل الطيور في حال كونها ((مَحْشُورَةً))، أي مجموعة له ((كُلٌّ)) من الجبال والطير ((لَّهُ))، أي لداود ((أَوَّابٌ))، أي رجّاع، فكانت الطيور تردد معه التسبيح، كما تردد الجبال، وقيل أنها كانت تطيعه فيما يأمر به.
((وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ))، أي قوينا ملك داود بالحرس والمال وكثرة العدة <العدد؟؟> والعدة، ((وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ))، المراد بها إما النبوة أو أن يكون بحيث يعرف مواضع الأشياء، فإن الحكمة هي عبارة عن علم وضع الشيء في موضعه اللائق به، ((وَفَصْلَ الْخِطَابِ))، أي الخطاب الفاصل بين الحق والباطل، والمراد به علم القضاء، فإنه كان يعرف كيفية الحكم بين الناس ومعرفة تمييز المحق من المبطل، وقد كان من ذلك قاعدة "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر."
ثم ينتقل السياق لينتقل <لينقل؟؟> قصة امتحن الله بها داود (عليه السلام)، فقد جاء خصمان إلى داود في شكوى، ولما سمع داود من المدعي كلامه حكم له بدون أن يستمع من المنكر، وكان هذا الاستعجال تركاً للأولى بالنسبة إليه، ثم توجه وأناب إلى الله سبحانه، وقد كان أمثال هذه المخالفات - المسماة بترك الأولى - تصدر من الأنبياء أحياناً لإثارة النشاط في نفوسهم، لتقوى اتصالاتهم بالله سبحانه، وهي لم تكن معصية - كما لا يخفى - كما أن نقلها في القرآن لعلها بسبب أن لا يعتقدوا الناس فيهم الألوهية، فإن من عادة الناس أن يرفعوا الإنسان النزيه فوق مرتبته، كما رفعوا عيسى وعلي بن أبي طالب (عليهما السلام) إلى مقام الألوهية، أما إذا علموا بصدور ترك أولى منهم كان ذلك حاجزاً دون الغلو، ومن غريب الأمر أن جماعة اختلقوا حول هذه القصة أكاذيب استناداً إلى "العهدين" المحرف، فذكروا قصة "أوريا" - كما نسبوا إلى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) اسطورة قصة "زينب"، وقد روي في المجالس عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: رضى الناس لا يملك، وألسنتهم لا تضبط، ألم ينسبوا إلى داود أنه تبع الطير حتى نظر إلى امرأة "أوريا" فهواها، وغنه قدم زوجها أمام التابوت حتى قتل، ثم تزوج بها، وقد روي عن الإمام المرتضى (عليه السلام) أنه قال: "لا أوتى برجل يزعم أن داود تزوج امرأة أوريا إلا جلدته حداً للنبوة وحداً للإسلام".
((وَهَلْ أَتَاكَ)) يا رسول الله، وهذا تشويق نحو القصة التي ستذكر ((نَبَأُ الْخَصْمِ))، أي خبر الخصمين، والمراد بالخصم الجنس، ولذا يشمل النفرين، أي هل بلغك خبر الخصمين ((إِذْ تَسَوَّرُوا))، أي صعدوا على السور لينزلوا ((الْمِحْرَابَ)) محل عبادة داود (عليه السلام)؟ فقد كان في المحراب، إذ رأى نفرين نزلا من سور المحراب، أي جداره، فهاله أمرهم، غذ لم يدخلوا من الباب، وإنما جيء بلفظ الجمع فقال "تسوروا" لأن الخصم جنس، والجنس عام، ويتحمل <يحتمل> أن يكونوا أكثر من اثنين، بأن أتياه مع بعض متعلقيهم، كما هو العادة في المنازعات.
((إِذْ دَخَلُوا)): الخصوم ((عَلَى دَاوُودَ)) من السور، ((فَفَزِعَ مِنْهُمْ)) وخاف منهم لأنهم دخلوا من غير الباب وبدون الإذن وفي غير الأوان، ((قَالُوا)) لداود: ((لَا تَخَفْ)) فلسنا نريد إيذائك، فإن الإنسان قد اعتاد أن يخاف من المفاجئ، لأنه يظن كون المجيء للإيذاء، وإلا كان يأتي على نحو المعتاد لا فجأة، إنما ((خَصْمَانِ)) أي نفران، أو طرفان ((بَغَى)) وظلم ((بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ))، فجئنا إليك لتحكم بيننا، ((فَاحْكُم)) يا داود ((بَيْنَنَا بِالْحَقِّ)) والعدل ((وَلَا تُشْطِطْ))، من الشطط، بمعنى الميل عن الحق والكذب والالتواء، وهذا القوم <القول> لم يكن لأجل احتمالهم أن داود يكذب ويجوز <يجور>، بل هكذا يقول الإنسان المخاصم ليرى طرفه والسامعين أنه واضح للحق مائل إليه، لا يريد جوراً وظلماً وتعدياً، ((وَاهْدِنَا))، أي أرشدنا في قضيتنا ((إِلَى سَوَاء الصِّرَاطِ))، أي وسط الطريق الذي لا جور فيه ولا انحراف.
ثم قال أحدهما لداود (عليه السلام): ((إِنَّ هَذَا)) الخصم ((أَخِي)) في النسب أو من باب الشفقة واللين في الخطاب، ((لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً)) أنثى الشاة، ((وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ)) فقط، ((فَقَالَ)) أخي لي - يريد سلب شاتي لتكمل له مائة شاة: ((أَكْفِلْنِيهَا))، أي ضم شاتك إلى نعاجي، واجعلني كفيلها حتى تكون لي ((وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ))، أي غلبني في الكلام ومخاطبته معي بأن خاشنني في الكلام بقصد أن يقهرني ويأخذ شاتي.
وبمجرد أن سمع داود كلام المدعي بدون أن يطلب من خصمه الرد ((قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ)) أخوك، وجار عليك في طلبه بنعجتك ((بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ)) ليضمها ((إِلَى نِعَاجِهِ))، ثم بين داود أن الظلم من عادة بعض الشركاء على بعض، ((وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ الْخُلَطَاء))، جمع خليط وهو الشريك لأنه يخالط الإنسان لأجل اشتراك أموالهما ((لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ))، حيث أن الأقوى منهم يريد أكل الأضعف، ثم استثنى من هذا العموم المؤمنين بقوله: ((إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ)) بأن كانوا مستقيمين عقيدة وعملاً، فإنهم لا يظلمون أحداً، ولم يكن حاجة إلى هذا الاستثناء لأنه نص أولاً بقوله "كثيراً"، وإنما جيء بالاستثناء - لئلا يوهم أن الكثير من المؤمنين - للتنصيص على أن أحداً من المؤمنين ليس بداخل في ذلك الكثير، ((وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ))، "ما" لزيادة التقليل، فإن المؤمن المستقيم في جميع شؤونه قليل جداً.
وإذ حكم داود بهذا الحكم قبل أن يستفسر من المدعي عليه الحال، تنبه إلى استعجاله الذي كان خلاف الأولى، ((وَظَنَّ)) حينذاك ((دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ))، أي امتحناه بهذه الحكومة، ويظهر من لفظ "ظن" أنه لم يتيقن، وإنما ترجح في نظره ذلك ((فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ))، أي طلب منه غفرانه، فإن ترك الأولى موجب للتنقيص من الثواب، فاستزاده بحاجة إلى الستر والغفران، وفرض أنه لم يكن، ((وَخَرَّ))، أي سقط داود لوجهه ((رَاكِعًا)) معظماً له سبحانه، فإن الركوع يطلق على مطلق التعظيم، ولو بنحو السجود، كما يدل عليه "خر"، وهو الأنسب بمثل هذا المقام، ((وَأَنَابَ))، أي رجع إلى ربه بعد الانشغال بتلك القضية، وقد ورد في بعض الأحاديث أن الخصمين كانا ملكين.
((فَغَفَرْنَا لَهُ))، أي لداود ((ذَلِكَ)) الترك للأولى، ((وَإِنَّ لَهُ))، أي لداود ((عِندَنَا))،أي في المحل المعد المكرم بكرامتنا - تشبيهاً بالمعقول بالمحسوس، ((لَزُلْفَى))، أي قربى وكرامة، من "زلف" بمعنى اقترب، ((وَحُسْنَ مَآبٍ))، أي المرجع الحسن في الآخرة.
ثم خاطبه الله سبحانه بقوله: ((يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ))، الخليفة هو الذي يجلس مكان غيره خلفاً له، والأنبياء خلفاء الله سبحانه، حيث أنه قررهم للقيام لأمره وإنفاذ حكمه في الأرض، وكان الإتيان بقوله "في الأرض" لإفادة العموم، فليس خليفة له في بلدة أو قطر، ((فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ)) المطابق للواقع، ((وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى)) التي تأمر الناس بالانحراف حسب العواطف والميول، ((فَيُضِلَّكَ)) اتباع الهوى ((عَن سَبِيلِ اللَّهِ)) وطريقه، وهذا ليس معناه أن داود كان محتمل الانحراف، وإنما الأوامر الصارمة توجه إلى الأنبياء كما توجه إلى غيرهم، كما قال سبحانه (ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك)، ((إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ))، أي يحرفون <ينحرفون؟؟> عن طريق الله بالحكم أو الفتوى أو الدعوة إلى الباطل ((لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ))، أي بسبب نسيانهم، والمراد بالنسيان تركهم أحكام الله، وحيث أن النسيان غالباً سبب لترك الأوامر كان الإتيان بالنسيان، وإرادة الترك مجازاً من علاقة السبب والمسبب، ويوم الحساب إما متعلق بـ"بما نسوا"، أي بسبب نسيانهم ليوم الحساب أو متعلق لـ"عذاب شديد" أي لهم عذاب شديد يوم الحساب بسبب نسيانهم أوامر الله.
وإذ وصلت القصة إلى هذا الموضع ألفت السياق الأذهان إلى حقيقة كبرى هي أن العالم لم يخلق باطلاً حتى يلائمه الحكم في القضايا بالباطل، بل العالم خلق بالحق وللحق، فاللازم أن تكون الأمور العملية من حكم وفتوى وغيرهما على الحق، وإلا كانت العاقبة الانهيار والدمار، ((وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا)) من البشر والملك والهواء وغيرها ((بَاطِلًا)): عبثاً واعتباطاً بلا غاية أو غرض حتى يكون الباطل من القول والعمل والحكم ملائماً للخلق ولا يكون له مصير مؤلم، ((ذَلِكَ))، أي كون الخلق باطلاً ((ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا)) بالله وجحدوا حكمه، وإنما قال "ظن" لأنهم يرجحون ذلك ولا يستفتونه، ((فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ)) التي تحرقهم لكفرهم وظنهم أن الخلق عبث باطل.
ثم توجه السياق إلى تنبيه الكفار بأنهم ليسوا سواء والمؤمنين لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل المؤمنون فوقهم مقاماً ومنزلة، ((أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا))، أي هل من الممكن أن نجعل المؤمنين، ((وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ))، اللازم منه عدم العمل بالمعاصي ((كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ))، فإن كل كافر وعاصي مفسد لنفسه أو غيره؟ كلا، لا نجعل المؤمن كالمفسد، ((أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ)) الذين اتقوا معاصي الله بعد الإيمان ((كَالْفُجَّارِ)) الذين عصوا وفجروا؟ من "الفجر"، وهو الشق، كان الفاجر يشق ستر الهدى، وينفذ نحو الباطل، ولعل المراد بالسؤال الثاني بيان عدم استواء المطيع والعاصي من المؤمنين بعد بيان عدم استواء المؤمن والكافر.
ومن ثم يأتي الكلام حول القرآن الحكيم ليلفت - بعد بيان القصص والآداب - إلى أنه كتاب عظيم، حيث اشتمل على مثل هذه الحقائق الرائعة، وقد ذكر في علم القرآن: إلقاء المطلب في الذهن بعد الإتيان بأمر معجب أنْفَذْ من الإلقاء في الذهن الخالي غير المتحرك، ألا ترى أن الإنسان إذا رق قلبه لأمر كان أسرع إلى العمل من أجله؟ وهذا ((كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ)) يا رسول الله ((مُبَارَكٌ)) ذو بركة وزيادة ونماء، كثير نفعه وخيره، لأنه يهدي ويرسم الخطط الموجبة للزيادة والخير ((لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ))، أي يتفكروا فيها ويتعظوا بها، ((وَلِيَتَذَكَّرَ)) مما أودع فيهم من الحقائق بالفطرة ((أُوْلُوا الْأَلْبَابِ))، أي أصحاب العقول، فإن اللب بمعنى العقل، أما غيرهم فإنهم لا يتذكرون ولا يتدبرون.
وإذ تمت قصة داود يأتي السياق لبيان قصة سليمان، ((وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ))، ومعنى الهبة العطية المجانية، والأولاد هبات للآباء، ولذا قال سبحانه: (يهب لمن يشاء إناثاً، ويهب لمن يشاء الذكور)، إنه ((نِعْمَ الْعَبْدُ)) إذ كان كأبيه يعمل بأوامرنا، ((إِنَّهُ أَوَّابٌ))، أي كثير الرجوع إلى الله سبحانه في جميع أموره، وقد سبق أن الإنسان إذا صرف إلى ضروريات حياته فكأنه ابتعد عن الله سبحانه، إذ لم يكن بجميع شراشره مشغولاً نحوه تعالى، ولذا كان الإلفات إليه بعد ذلك أوباً ورجوعاً.
اذكر يا رسول الله ((إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ))، أي على سليمان ((بِالْعَشِيِّ))، أي في آخر النهار ((الصَّافِنَاتُ))، جمع صافنة، وهي الخيل الواقفة على ثلاث قوائم، الواضعة طرف السنبك الرابع على الأرض، يقال صفنت الخيل إذا وقفت كذلك، وهي من علامة الجودة، ((الْجِيَادُ)) جمع جيد وهي الفرس الأصلية النجيبة، ونجابة الفرس بعرفانها صاحبها وسرعة سيرها والاهتمام بخلاص راكبها من المشكلة التي يقع فيها.
((فَـ)) أشتغل سليمان بتلك الأفراس، حتى فاتت صلاةً مندوبة كان يصليها في ذلك الوقت حتى غابت الشمس، ومضى وقت صلاته المندوبة، وهناك تأثر سليمان من ذلك، وأمر أصحابه برد الأفراس إليه ليوقفها في سبيل الله كفارة لفوت صلاته المندوبة أو يذبحها ليطعمها الناس كفارة، وهذا المعنى قد استفدناه من بعض الأخبار، مع التحفظ على ظاهر الآية، وما ثبت من عصمة الأنبياء (عليهم السلام)، وإن كان الواقع في القصة لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم.
ولما نظر سليمان إلى غروب الشمس وذهاب وقت نافلته ((قَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ))، أي أحببت الخير حباً، والخير هو الفرس، وكل مال هو خير، كما قال سبحانه (إن ترك خيراً)، ((عَن ذِكْرِ رَبِّي))، أي آثرت الاشتغال بعَرْضِ الأفراس عن ذكر الله ((حَتَّى تَوَارَتْ)) الشمس ((بِالْحِجَابِ)) كأنها عروس تستر نفسها بالحجاب حين تغيب وتستتر تحت الأفق، فلم أصلِ نافلتي.
ثم قال سليمان لأصحابه: ((رُدُّوهَا))، أي ردوا الصافنات ((عَلَيَّ))، فردوها إليه، ((فَطَفِقَ))، أي فشرع سليمان يمسح ((مَسْحًا بِالسُّوقِ))، أي سوق الأفراس جمع ساق ((وَالْأَعْنَاقِ))، أي ويمسح أعناقها، و"اللام" عوض عن الضمير، والمعنى يمسح سوقها وأعناقها تسبيلا في سبيل الله ووقفا لها على جهات الخير أو ضرباً بالسيف ليطعمها الفقراء، كل ذلك لتكون كفارة عن فوت نافلته بسبب اشتغاله بها.
((وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ))، أي امتحناه، وذلك بأنه ولد له مولد، فخاف عليه من إيذاء الشيطان، وجعله في السحاب ليكبر هناك، وقد كان السحاب مسخراً له، لكن ذلك كان خلاف التوكل من مثله (عليه السلام)، ولذا مات الولد، وألقي على كرسي حكمه، فلما رآه عرف أنه ترك الأولى في إيداع الولد السحاب، ((وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ))، أي على سرير حكمه ((جَسَدًا)) لولده الميت، ((ثُمَّ أَنَابَ))، أي رجع عن تركه للأولى.
((قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي)) اعتمادي على السحاب في إبقاء ولدي وعدم أذى الشياطين له ((وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي))، لعله أراد نوعاً من الملك يكون ذو إعجاز لا يتمكن أحد من الإتيان مثله، كما أن عصا موسى وإحياء عيسى وقرآن الرسول كانت بحيث لا ينبغي لأحد من بعدهم، فلم يرد سليمان البخل وتخصيص رحمة الله بنفسه، بل أراد الإعجاز، والذي يؤيد ذلك أن الملك الذي وهب له كان معجزة، إذ هو تسخير الريح، وعبارة "لا ينبغي لأحد" يراد به الناس لا حتى الأنبياء، فإن مثل هذا التعبير شائع، قال الرسول (صلى الله عليه وآله سلم): "ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر." ولم يرد (صلى الله عليه وآله سلم) ترجيحه على الأئمة، كما أن قوله سبحانه في القرآن الكريم (ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها) أريد به ممن آمن وعصى لا من كل أحد، وهكذا ومثله تعبير عرفي شائع، ((إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ)) الكثير الهبة، فتفضل عليّ بذلك.
((فَسَخَّرْنَا))، أي ذللنا بأمره ((لَهُ))، أي لسليمان ((الرِّيحَ)) التي كانت تحمل بساطه وتسير به إلى حيث شاء، ((تَجْرِي)) الريح ((بِأَمْرِهِ))، أي أمر سليمان ((رُخَاء))، أي لينة بدون عنف ((حَيْثُ أَصَابَ))، أي إلى كل مكان أراد الذهاب إليه، والإصابة هي الوصول إلى الشيء، وكان المعنى حيث أصحاب <أصاب؟؟> نظره وإرادته.
((وَ)) وسخرنا له ((الشَّيَاطِينَ)) أي الأجنة، وقد سبق أن الشيطان قسم من الجن وإن كان له نوعان، نوع يسمى جِنّاً، ونوع يسمى شيطاناً، ((كُلَّ بَنَّاء))، أي يبني له القصر والدار وما أشبه في المدن والصحاري، ((وَغَوَّاصٍ)) في البحر يذهب في الماء ليأتي له بالجواهر واللآلئ، و"كل" يدل من الشياطين بدلاً من الكل.
((وَ)) سخرنا له شياطين ((آخَرِينَ)) غير البناء والغواص في حال كونهم ((مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ)) جمع صفد، وهو الغل، فقد كان يجمع بين بعض الشياطين مع بعض في السلسلة تعذيباً لهم على تمردهم، أو لئلا يفر المتمرد منهم، أو كان يغل المتمرد يديه ورجليه، وهذا كناية عن إعطاء زمامهم بيده حتى أنه يتمكن من استخدامهم وعقاب المجرمين منهم.
وبعد هذا الملك الوسيع الخارق، قال الله سبحانه لسليمان - زيادة لا كرامة - ((هَذَا)) الملك ((عَطَاؤُنَا)) لك، ((فَامْنُنْ)) على من شئت بإعطائه ما تشاء، ((أَوْ أَمْسِكْ)) عمن شئت، بأن لا تعطيه شيئاً في حال كونك ((بِغَيْرِ حِسَابٍ))، أي أنك لا تحاسب عما تفعل، أو أعط بغير حساب وتعداد من شئت، فهو متعلق بـ"امنن".
((وَإِنَّ لَهُ))، أي لسليمان ((عِندَنَا))، أي لدينا ((لَزُلْفَى))، أي قرباً منّا، فإنه ذو جاه عند الله سبحانه، ((وَحُسْنَ مَآبٍ))، أي مرجعاً في الآخرة.
((وَاذْكُرْ)) يا رسول الله ((عَبْدَنَا أَيُّوبَ)) كيف صبر على البلاء، فإنه (عليه السلام) ذهب ماله وأهله وأولاده، وتمرض جسده بأشد أنواع المرض، ولم يزل يذكر الله ويشكره حتى إذا بلغ الأمر منتهاه وأراد الله سبحانه له الشفاء بعد أن أحس الصبر ونجح في الامتحان ((إِذْ نَادَى رَبَّهُ)) تعالى قائلاً: يا رب ((أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ))، فإن الشيطان هو الذي صار سبباً لبلاء أيوب، وقد مكنه الله سبحانه منه بأن لم يصده عن إيذائه - كما لم يصده عن الوسوسة لآدم (عليه السلام) - امتحانا لأيوب، وليرتفع بذلك مقامه، و"النصب" هو البلاء، و"العذاب" هو الألم، ولعله أراد باللفظين الألم الجسمي والروحي أو ألمه في أهله وماله وأولاده وألمه في نفسه.
وبعد أن دعا أيوب ربه لينجيه من البلاء خُوطِبَ من قِبله سبحانه: ((ارْكُضْ بِرِجْلِكَ))، أي ادفع برجلك الأرض، فإن الركض هو الدفع بالرجل على جهة الإسراع، ومنه يسمى المشي السريع ركضاً، فركض (عليه السلام) برجله الأرض، فظهرت عين ماء، فقيل له: ((هَذَا)) الذي تراه ((مُغْتَسَلٌ))، أي موضع يغتسل فيه، وقد أريد بذلك تنبيه على الاغتسال في ذلك الماء، ((بَارِدٌ))، الإتيان بهذا الوصف للترويح عن النفس المريضة الملتهبة التي تطلب الماء البارد، ((وَشَرَابٌ)) يشرب منه، وقد اغتسل أيوب في ذلك الماء، وشرب منه، فصح جسمه كأن لم يكن به مرض أبداً.
((وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ)) الذين ماتوا في البلاء بأن أحياهم الله سبحانه ((وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ)) إما بأن وَلد له أولاد آخرون على عدد أولئك الأولاد حتى صار له من الأولاد ضعف أولاده قبل البلاء، وإما بأن المراد إعطاء أهله الذين ماتوا قبل البلاء والذين ماتوا في البلاء، وذلك لأنه استحق الذين ماتوا في البلاء لا الذين ماتوا قبله بآجالهم الطبيعية، وإنما فعلنا ذلك ((رَحْمَةً مِّنَّا)) له وتفضلاً عليه، فليس أحد يستحق على الله شيئا،.............................الخ